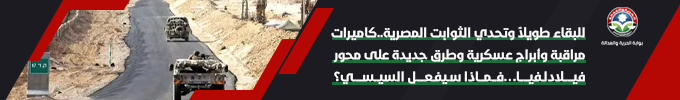أوقعت الهبات العربية في إطلالتها الأولى مفاجأة في أوروبا، حيث خيّم الصمت والارتباك على المشهد الأوروبي حتى أواسط فبراير 2011، إلى أن تيقن الجميع أن عرش مبارك يهتز حقا بعد سقوط نظام بن علي، وما إن انتقلت جذوة الانتفاضة الشعبية إلى مصر حتى اتضح أنّها مرحلة عربية جديدة، وليست حدثا تونسيا معزولا.
ولما التهبت القاهرة غضبا في 25 يناير 2011، انصرفت عواصم أوروبا للوهلة الأولى إلى اهتماماتها التقليدية، من أمن قناة السويس، ودور الإسلاميين المُرتَقب، إلى الانشغال الفائق بالرقعة الواقعة شرقا حيث توجد فلسطين المحتلة، ولم تكن أذهان الصفوة الأوروبية قد تهيأت بعد لاستيعاب التحول الذي يفرض العامل الجديد، وهو الشعوب.
وليس سراً أن السياسات الخارجية البرجماتية الأوروبية والأمريكية فضلت ذئاب العسكر، لضمان استقرار مزارع الأغنام العربية التي تحلب سمن وعسل لأوروبا وأمريكا، وحماية المصالح ومكافحة الإرهاب وكبح الهجرة، على دعم الديمقراطية وإطلاق الحريات في العالم العربي، هذه الممارسات الأوروبية الشنيعة كشفت النفاق الأوروبي تجاه الديمقراطية.
أوروبا التي ترصد مليارات الدولارات لدعم البرامج الديمقراطية في إفريقيا وآسيا، وتسلّط مؤسساتها الحقوقية والبرلمانية ضد التجارب الفتية الديمقراطية، لا تفعل ذلك لعيون الديمقراطية ولا لنشر الحريّة، بل لتحقيق مصالحها وتمرير مشاريعها وأهدافها.

ديمقراطية الذئاب
لهذا تمادت الذئاب الحاكمة في البلاد العربية في انتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتصميم انتخابات شكلية وفرض حالة الطوارئ، مع تمتّعها بحصانة خارجية من اللوم أو المحاسبة أو حتى من الانتقاد الإعلامي الجاد، وليس صحيحا أن الحكم العسكري هو الذي يستطيع إدارة شؤون مصر، وحمايتها مما تتعرض له من فتن ومؤامرات.
ولنا في التاريخ القريب والبعيد عبرة ودليل على فشل هذا الحكم في إدارة الدولة، وتسببه في هزائم كبرى لا زلنا نعاني تداعياتها حتى الآن، وتعريضه أمنها للخطر، بل وإقدامه مؤخرا على التفريط في سيادتها وبيع جزرها، والتنازل عن حقوقها المائية والغازية، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة بتركة ثقيلة من الديون عديمة الجدوى، ونشر الفساد، وتقنينه، وحماية الفاسدين، بل وتكريمهم بتوليتهم أرفع المناصب، كما تم مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والمتهم في قضايا فساد كبرى منذ العام 2011.
وكان الكاتب الصحفي المُقرب من مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، ياسر رزق، قد دعا الأسبوع الماضي، برلمان الدم الموالي للانقلاب إلى ضرورة تعديل دستور العسكر خلال عام 2019 لتمكين قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم، عبر وضع مادة انتقالية تسمح بزيادة فترة حكمه ولا تسري إلا على السفيه السيسي فقط.
وطالب “رزق” بتشكيل ما سماه مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة لاتخاذ “التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها، واستحداث مادة جديدة تنص على أن القوات المسلحة هي الحارس على مبادئ ثورة 30 يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو”، على حد قوله.
ووفقا لدستور الانقلاب الحالي، فإنه ليس بوسع السفيه السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولاية الاستيلاء على الحكم في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين، ويبقى العلم أن الحكم العسكري ليس قدرا مقدورا على المصريين، وبإمكانهم التخلص منه، كما فعلوها لوقت قصير بعد ثورة يناير.
مصالح أوروبية
وقد عاشت الكثير من الشعوب تحت حكم عسكري لعقود طويلة، لكنها تخلصت منه، وأسست حكما مدنيا نجح في نقلها من مصاف الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة، ولنا في تركيا خير مثل، فقد انتقلت في ظل الحكم المدني المستقر إلى مصاف الدول المتقدمة، وأصبحت واحدة من مجموعة العشرين الصناعية الكبرى، وتخطط لتبوء صدارة المجموعة.

وهذا الحلم لم يكن ليتحقق لو استمرت تحت الحكم العسكري، كما تطورت دول أمريكا الجنوبية التي طلقت الحكم العسكري، ومثلها الدول الأفريقية التي تخلصت من حكامها العسكريين، وأصبح استمرار الحكم العسكري وصمة في جبين كل مصري يقبل به، بعد أن عاش المصريون تجربة قصيرة لحياة الحرية والكرامة والعدالة بعد ثورة يناير.
والنتيجة التي لا تُمحَى من ذاكرة الشعوب، أنّ أوروبا خذلت التحوّل الديمقراطي العربي في لحظة الحقيقة، ولم ترفع صوتها أو تستخدم نفوذها لوقف الانقلابات التي تعيد إنتاج نصف قرن من الطغيان، أمّا التباكي بالوقوف “في الوسط” بين مناصرة الديمقراطية ونقيضها، فهو تواطؤ آثِم لا يمكن تبريره.
بعد ست سنوات من اندفاع الشعوب للانعتاق من حقبة الاستبداد، فقدت الحفاوة الرسمية الأوروبية بالربيع العربي مصداقيتها، وتأكّد مرّة أخرى أنّ تقديرات راسمي المصالح وموجِّهي سياسات الأمن القومي هي التي تحدِّد وجهة السياسة الخارجية، وليس التلاعب اللفظي بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
صفحة جديدة تُضاف اليوم إلى ذاكرة العرب بعد سحق ديمقراطية الجزائر وخنق ديمقراطية فلسطين، تنكّرت أوروبا سريعاً للربيع العربي، ولم تصمد مقولاتها الجميلة في مديح الشعوب في لحظة الحقيقة، أمّا شهادات التقدير وألقاب التكريم الأوروبية لنجوم “الربيع العربي” الذين لا يذكرهم أحد اليوم، فتحوّلت إلى تذكارات من الزمن الجميل.